**الإنسان بين ضعفين- تأملات في سيرة الضعف القرآني**
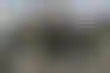
إن الفقد الجلل لوالدي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، منذ بضعة أسابيع، قد أيقظ في نفسي تدبرات عميقة حول حقيقة الموت، تلك التجربة الإنسانية الشاملة التي نعايشها جميعًا بأوجهٍ متنوعة ومفاهيم مختلفة، تتأثر بحالاتنا النفسية والاجتماعية والعائلية.
لكن هذه المرة، وقفتُ أمام آية قرآنية جليلة، وكأنني أرتوي معانيها للمرة الأولى، مستحضرًا شريطًا من الذكريات المتشابكة، جوهره الثابت هو التحول المستمر في أحوال الإنسان. تلك الآية الكريمة: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ). هذا الضعف، الذي يحيط بالإنسان منذ ولادته وحتى نهايته، على الرغم من وجود فترات قوة عابرة، تؤكده آية أخرى: (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)، وآية ثالثة: (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا). هذه الآيات الثلاث تترادف لتصف الضعف الذي يلف الإنسان من كل جانب، وتؤكد حقيقة أن أحواله في تبدل دائم ومستمر.
وإذا ما اتسعت دائرة تدبرنا قليلاً، فسنجد في القرآن الكريم آيات وافرة تتناول جوانب متعددة للإنسان، تشمل الجوانب الوجودية والنفسية والأخلاقية وغيرها، وكأنها بمجموعها ترسم صورة متكاملة للإنسان، تختلف عن الصور النمطية التي يكتبها الإنسان عادة عن نفسه. وإذا نظرنا إلى كلمة "الإنسان" في هذه الآيات، واعتبرنا أن "أل" فيها تدل على الجنس أو النوع، فإن هذه الصورة ستكون بمثابة سيرة للنوع الإنساني بأكمله. أما إذا اعتبرنا أن "أل" للعهد، واقتصرنا على سياقات محددة لتلك الآيات، فإن هذه الصورة ستكون بمثابة سيرة لنمط أو نوع معين من بني البشر.
تتضح في القرآن الكريم ملامح هذه السيرة المغايرة، إذ تتناول الجوانب النفسية للإنسان، وتكشف عن تقلبات انفعالاته السلوكية، وتستعرض طبائعه وأخلاقه في حالاته المتبدلة باستمرار. فمن الآيات التي تتحدث عن جوانبه النفسية: (وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا)، (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا). ومن الآيات التي تتحدث عن طبائعه وأخلاقه: (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ)، (وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا)، (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا)، (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ)، (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ)، (وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا)، (إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)، (فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ)، (لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ)، (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ)، (قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ)، (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى)، (وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا)، (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا).
ولكن الآية المحورية، التي أطلق عليها "آية الضعف"، والتي استدعت مني كل هذا التدبر في سيرة الإنسان كما يرسمها القرآن الكريم، ترسيم خطًا بيانيًا لوجوده الدنيوي، وتكشف عن أن وجود الإنسان ممزوج بالضعف، سواءً من حيث مادة خلقه الأولى أم من حيث المراحل والتحولات التي يمر بها خلال حياته القصيرة. إن قوته العارضة محاطة بضعفين، ضعف البداية وضعف النهاية الذي يختتم حياته الدنيوية التي تنطوي على مشقة وكد (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) و (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ).
ولكن ما هي تجليات هذا الضعف الذي يطبع مسيرة الإنسان؟
بالنظر إلى الجانب اللغوي والنحوي في الآية، نجد أمرين جديرين بالاهتمام: الأول هو أن لفظي "الضَّعف" و "الضُّعف" هما لغتان فصيحتان في اللغة العربية، وقراءتان صحيحتان للآية. والثاني هو أن كلمة "ضعف" تكررت بصيغة التنكير. هذان الأمران اللغويان يمكن أن يقدما لنا مفتاحًا لفهم الضعف بأبعاده المتشابكة والمتراكبة، كما سنوضح. فالضُّعف بالضم هو لغة قريش، بينما الضَّعف بالفتح هو لغة تميم، والمعنى العام لكلا اللفظين هو أنهما نقيض القوة. إلا أن العديد من علماء اللغة قد ميزوا بين اللفظين من حيث المعنى، ورأوا أن الفرق بينهما ليس مجرد فرق لفظي، فالضَّعف بالفتح يتعلق بالعقل والرأي، بينما الضُّعف بالضم يتعلق بالأمور الجسدية. وقد ذهب بعضهم إلى تفسير الضعف هنا تفسيرًا قرآنيًا، مشيرين إلى أنه يحيل إلى مادة الخلق، وهي النطفة، ووصفها بأنها (ماء مهين).
أما تنكير كلمة "ضعف"، فهو يخرج هنا عن القاعدة التي قررها علماء النحو، والتي تنص على أن النكرة إذا أعيدت نكرة كان معنى النكرة الثانية غير معنى النكرة الأولى. وآية الضعف هي مثال من بين أمثلة قليلة تخرج عن هذه القاعدة النحوية، لأن الضعف هنا هو نفسه وإن تكرر بصيغة التنكير، فهو يشير إلى الضعف بوصفه نوعًا لا فردًا، ويشمل ألوانًا متنوعة من الضعف. وبالمثل، فإن القوة التي تتوسط بين ضعفين هي قوة نوعية أيضًا.
إن كون الضعف الذي يحيط بالمسار الوجودي للإنسان في هذه الحياة ضعفًا نوعيًا، يفتح آفاقًا دلالية واسعة لمفهوم الضعف في القرآن الكريم، خاصة إذا استحضرنا الآية الكريمة الأخرى التي تقول: (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)، بحيث يصبح الضعف صفة ملازمة لخلق الإنسان وتقلب أحواله الوجودية. ويمكننا هنا أن نتحدث عن أربعة مستويات للضعف:
- أولًا: الضعف بالمقارنة مع الملأ الأعلى، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ).
- ثانيًا: الضعف البنيوي، أي بالنظر إلى الإنسان بذاته، بمعزل عن ما يقويه من فيض الله ومعونته. من هنا، أضاف الإمام الراغب الأصفهاني نوعًا من الفضائل سماه "الفضائل التوفيقية"، وتبعه في ذلك الإمام أبو حامد الغزالي، وهذا النوع يعتبر إضافة إسلامية إلى مصفوفة الفضائل اليونانية. وإلا فإنه "إذا اعتُبر الإنسان بعقله، وما أعطاه الله من القوة التي يتمكن بها من خلافته في أرضه، ويتبلغ بها في الآخرة إلى جواره – تعالى – فهو أقوى ما في هذا العالم"، كما قال الراغب.
- ثالثًا: الضعف بالنظر إلى كثرة حاجات الإنسان في وجوده الدنيوي، ومن ثم احتياج الناس بعضهم إلى بعض. ومن هذا المنطلق، جرى علماء الإسلام على القول بأن الإنسان مدني بطبعه (نسبة إلى المدينة)، أي أنه اجتماعي. ومن ثم، جاءت تقويته بالعبادات والشعائر الجماعية (كالجماعة والجمعة والعيدين وغير ذلك) من جهة، وبمنظومة من الأحكام الفقهية والأخلاقية التي تنظم علاقته بغيره، وتصون حقوقه وحقوق غيره من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق يمكن رد الفقه الإسلامي بكل تفصيلاته إلى منظومة ثلاثية: حقوق العباد، وحقوق الله، والحقوق المشتركة بين الله والعباد، ويمكن إضافة رابع لها وهي حقوق الحيوان.
- رابعًا: الضعف بالنظر إلى بداية الإنسان ونهايته، فآية الضعف نص في هذا النوع من الضعف الذي يتعلق بتبدل أحوال الإنسان بحسب الجسم والروح والمكان والزمان. فخلق الإنسان من نطفة أو من ماء مهين يؤكد مبلغ الضعف في نشأته منذ البداية (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ). وكما أن الشيبة التي قُرنت بالضعف الأخير الذي يعقب القوة، هي إشارة إلى أن هذا الضعف لا قوة بعده، وأن بعده العدم، ولهذا شاع أن الشيب نذير الموت، وهو نهاية أحوال الإنسان وتبدلاته، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في موضع آخر بعبارة "أرذل العمر" بدل الشيبة (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا)، حيث يصاب الإنسان في هذه السن بضعف القوى البدنية والعقلية والنفسية، ولهذا قال: (لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا). وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: "اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل والهرم، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات".
من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا الضعف الذي يحيط بالإنسان من كل جانب في مسيرته الوجودية في الحياة الدنيا، قُدّم في آية الضعف على أنه دليل على أمرين:
- الأول: أنه دليل على علم الله تعالى وكمال قدرته التي لا يعتريها إعياء ولا ضعف ولا نقص بأي شكل من الأشكال. وقد أظهر الله تعالى هذا الدليل من خلال ذكر أحوال الإنسان التي تنتمي إلى دلائل الأنفس، ومن خلال أحوال الريح التي جاء ذكرها قبل ذكر أحوال الإنسان والتي تنتمي إلى دلائل الآفاق وهي قوله: (اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا)، كما أشار إلى ذلك عدد من المفسرين، منهم الإمام فخر الدين الرازي.
- الثاني: إمكانية البعث يوم القيامة، وتقريب حصوله إلى أذهان منكريه، لأن تعدد صور إيجاد المخلوقات وكيفياتها من ابتدائها عن عدم، أو من إعادتها بعد انعدامها، بتطور أو بدون تطور، مما يزيد إمكانية البعث وضوحًا لدى المنكرين، كما قال الشيخ الطاهر بن عاشور.
على الرغم من أن الآية الكريمة تقرر حقائق قد تبدو بديهية، إذ إنها تتصل بسنن الله في الأنفس، إلا أن الهدف من تقريرها والإفصاح بها أمران:
- الأول: التذكير بالضعف والوعظ به أيضًا، لأن ميل الإنسان نحو النسيان والطغيان والتسلط قد يجعله ينسى ضعفه، وأن أحواله لا تستقر على حال، لا في القوة ولا في المكان ولا في المكانة. لذلك، كان من حكمة الله سبحانه أن يري العبد ضعفه، وأن قوة العبد تتوسط بين ضعفين، ولولا تقوية الله له لما وصل إليها، بل لو استمرت قوة الإنسان في الازدياد لطغى وبغى وجاوز الحد.
- الثاني: الإخبار عن الدنيا بأنها دار زوال وانتقال، لا دوام فيها ولا استقرار، والحث على التعقل وترك التهور. ولهذا قال عز وجل: (أَفَلَا يَعْقِلُونَ)، أي يتفكرون في سيرتهم وتقلب أحوالهم ثم صيرورتهم إلى مرحلة الضعف الأخير والشيخوخة، وذلك أنهم إنما خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها.
